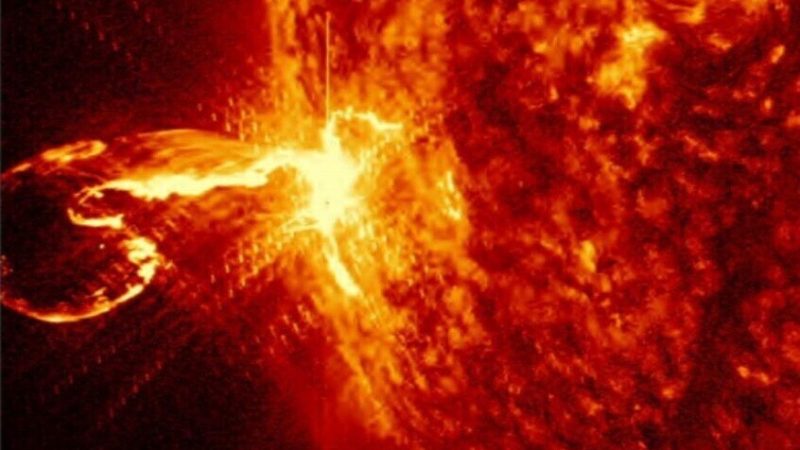أربعة حراكات شعبية جديدة قد تغير وجه منطقة الشرق الأوسط

شهدت المنطقة العربية في الأشهر الأخيرة أربعة حراكات شعبية، في الجزائر والسودان والأردن وقطاع غزة، وحاول البعض وصفها بأنها الموجة الثانية، أو “الحركة التصحيحية” لموجة “الربيع العربي”، الأولى التي انطلقت من تونس ثم امتدت إلى في مصر وتونس وليبيا واليمن وسورية في عام 2013، ونجحت في تغيير بعض الأنظمة كليا، وخاصة في ليبيا وتونس، وجزئيا في مصر واليمن، بينما فشلت في سورية، وجرى امتصاص نظيرتها في المغرب وسلطنة عمان، والأردن في بداياتها من خلال بعض الإجراءات الإصلاحية السريعة، والتعاطي المدروس.
الحراكات الأربعة المذكورة آنفا، أي في الجزائر والسودان والأردن وغزة، ليست متطابقة، ولا يمكن حصرها في قالب واحد، فالأمور نسبية، والمقارنة ليست جائزة، وتختلف كليا عن نظيراتها في الموجة الأُولى ويمكن رصد هذا الخلاف بين الموجة الحالية ونظيرتها السابقة قبل ثماني سنوات في النقاط التالية:
أولا: قناة “الجزيرة” التي لعبت الدور التحريضي الأول في الحراكات الأولى في تغطية امتدت على مدى 24 ساعة، وفي ظل تحشيد غير مسبوق لعشرات، وربما مئات، المحللين والخبراء “العسكريين”، غابت كليا عن الحراكات الأربعة الأخيرة، أو لم تغطها بالكثافة السابقة، لأسباب عديدة، يعود أبرزها إلى تجربة “الثورة” السورية، وفشلها في إطاحة النظام، وافتضاح الدور الاستخباري الغربي فيها، وتسليح معظم فصائلها، واختراقها من قبل الجماعات السلفية المتشددة، واللعب على وتر الطائفية.
ثانيا: لعبت حركات إسلامية، دورا بارزا في معظم هذه الثورات، وبدعم من قوى خارجية، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا خاصة، وتمويل سعودي قطري، بينما لم يتم رصد أي دور مماثل لهذه الحركات الإسلامية في أي من الحراكات الأربعة المذكورة آنفًا، وهذا ما سنشرحه لاحقا.
ثالثا: موجة الثورات العربية الأُولى، وخاصةً في مصر وليبيا وسورية وتونس أبرزت “نجوما”، ومن الإسلاميين خاصةً، مثل الشيوخ يوسف القرضاوي، وسلمان العودة، محمد العريفي، عدنان العرعور، علي الصلابي، راشد الغنوشي، وأصبح هؤلاء وغيرهم المنظرين الحقيقيين لهذه الثورات، استخدموا وسائط التواصل الاجتماعي مثل “الفيسبوك” و”التويتر” لتعبئة الشارع العربي، ووصل أتباع هؤلاء في العالم الافتراضي إلى الملايين، لكن هؤلاء النجوم وأمثالهم غابوا كليا عن الموجة الثانية من الحراك، سواء لأن الجماهير تعلمت دروس التجربة السابقة، أو لأن معظم المشاركين فيها من الشباب المؤطر غير المؤدلج، ووجود حرص أكيد على عدم إفساح المجال للإسلاميين بالمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، أو قيادتها على الأقل.
رابعا: تمسك جميع الحراكات الأربعة بالسلمية، وعدم الدخول في مواجهات مع رجال الأمن، وتجنب أعمال النهب والتكسير للممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ بقدر الإمكان على مؤسسات الدولة وهياكلها، مما يعكس الحرص على تجنب “خطايا” الموجة الأُولى التي أنتجت دولا فاشلةً مثل الليبية واليمنية.
خامسا: غياب الدعم الخارجي، الغربي والعربي معا، لرفض المحتجين الجدد له، وفي الجزائر والسودان تحديدا، وانشغال دول مثل قطر وتركيا، أبرز الداعمين للحركات الإسلامية التي قادت الموجة الأولى بأزمات داخلية، مثل تعرض قطر لحصار من الدول الأربع المقاطعة لها (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، وتركيا لانقلاب عسكري، وأزمات اقتصادية، وموجات هائلة من النازحين (3.5 مليون لاجئ سوري).
سادسا: خفتان وهج النموذج التركي الإسلامي الذي أرسى دعائمه الرئيس رجب طيب أردوغان، ووضع تركيا في المرتبة الـ13 على قائمة أقوى اقتصاديات في العالم، وهو نموذج قام على ثلاثة أسس، الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والإسلام المعتدل، ولعل التدخل التركي في الأزمة السورية، وتدخل قوات تركية وسيطرتها على بعض المناطق في سورية ووصفها بالاحتلال، والاعتقالات الواسعة التي وقعت بعد الانقلاب العسكري، هزت هذا النموذج لصالح نموذج الدولة المدنية الديمقراطية.
سابعا: الفشل الإداري، والفوضى السياسية والأمنية التي سادت معظم دول الموجة الأُولى من الربيع العربي جعلت من الجماهير العربية الأكثر حذرا، والاقل حماسا، وتقديم بعضها الأمن والاستقرار على الإصلاحات الجذرية، واستغلال الحكومات الديكتاتورية والثورات المضادة لهذا التحول وتغذيته، وقفز المؤسسات العسكرية إلى سدة الحكم بشكل مباشر وغير مباشر، واستخدام القبضة الحديدية ضد معارضيها.
ثامنا: وقوف الاحتياطات المالية الخليجية الهائلة إلى جانب الأنظمة البديلة، وخاصة في مصر، وضخ أكثر من 50 مليارا لدعم اقتصادها، وتوظيف المليارات في تأسيس امبراطوريات إعلامية مضادة، وجيوش إلكترونية عملاقة للتصدي للإسلاميين وقنواتهم ورموزهم، ومحاولة تقليص نفوذ “الجزيرة”، وإنهاك قطر، وتركيا، بدرجة أقل، في معارك قضائية وحروب علاقات عامة، وتجسس إلكتروني، ومئات المواقع إلكترونية، كلها عوامل أدت إلى إثارة شكوك الشارع العربي، وإداركه لحالة الاستقطاب الراهنة وآثارها السيئة، ونهجها الدعائي المضلل.
تاسعا: رغم غياب الرموز والقيادات في الحراكات الشعبية الحالية، إلا أن مستوى التنظيم والانضباط كان عاليا، والشيء يقال أيضا عن حالة الوعي التي تعكس حسابات دقيقة، فالمتظاهرون في الجزائر كرروا دائما أمرين أساسيين: الأول أنهم لن يسمحوا بتكرار أخطاء التجربتين الليبية والسورية وإغلاق الأبواب بإحكام في وجه كل من يريد تسليح الجماهير، أو السماح بتسلل المتطرفين العقائديين إليها، والثاني تجنب التقسيمات الطائفية والعرقية، والحفاظ على الوحدة الوطنية حتى الآن على الأقل، والرد على المخاوف من نظرية المؤامرة بالتمسك بالاستقلالية المطلقة عمليا، ومقاومة التدخلين العربي والغربي.
عاشرا: اللافت أن الحكومات بدأت تتعلم من تجارب نظيراتها في الجولة الأولى، من حيث مقابلة السلمية بالسلمية من قبل رجال الأمن، مثلما حصل في الأردن والسودان والجزائر، وليس في غزة، والتحلي بضبط النفس الأمني، واستخدام الحد الأدنى من وسائل القوة، وتقديم تنازلات جوهرية، ففي السودان تعهد الرئيس البشير بعدم تعديل الدستور، وخوض الانتخابات المقبلة على رأس حزبه، وأجرى بعض التغييرات في قمة الحكم، وفي الجزائر اضطر الرئيس بوتفليقة، أو المجموعة التي كانت تستخدمه كواجهة، وتحكم من خلف الستار، إلى إلغاء العهدة الخامسة، وانتخاباتها، ووضع دستور جديد للبلاد، وتشكيل لجنة وطنية للحوار لتغيير طبيعة نظام الحكم، ولجنة بأُخرى جديدة مستقلة للانتخابات، وإقالة الحكومة، ومن غير المستبعد أن يؤدي استمرار الاحتجاجات بالزخم الذي رأيناه يوم الجمعة الماضي إلى تنازلات أُخرى على طريقة أحجار الدومينو.
إحدى عشر: الحراك الشعبي الذي انفجر في قطاع غزة ضد حركة “حماس″، وحمل شعار “بدنا نعيش” كان الوحيد تقريبا من بين أقرانه الثلاثة الأخرى الذي خالف بعض القواعد والاستخلاصات المذكورة آنفا، أولا، لأن شرطة “حماس” السرية والعلنية، استخدمت درجات عالية من القمع في مواجهة المتظاهرين، ومعظمهم من الجوعى والمطحونين، وجرى تكسير الأطراف لبعضهم، والاعتداء بالضرب على النساء، واقتحام المنازل في مجتمع محافظ جدا، وثانيا، لدخول السلطة في رام الله على الخط من منطلق التنافس والتباغض الفصائلي، وترددت أنباء لا نعرف مدى صحتها تؤكد على إدراك قيادة “حماس” لفداحة أخطائها واعتذارها، وإذا تأكد هذا فإنه يشكل مراجعة مهمة، مع الأخذ بالاعتبار أن ظروف قطاع غزة الواقع تحت الحصار الخانق ماليا وسياسيا تختلف كليا عن جميع الحراكات السابقة.
*
الهجمة الأمريكية والإسرائيلية الشرسة ضد العرب والمسلمين، وهزيمة “الدولة الإسلامية” (داعش) في العراق وسورية، والأزمة المتفاقمة في العلاقات الأمريكية التركية، على أرضية صواريخ “إس 400” الروسية، والحرب الأمريكية على الليرة التركية التي تجددت وفشل محاولات الفتنة الطائفية، وتقسيم المنطقة على أساسها، وصمود الجيش العربي والتعافي التدريجي المتسارع في سورية والعراق، واقتراب الأخير (العراق) من محور المقاومة، وإسقاط ترامب صفة الاحتلال عن الضفة والقطاع والجولان، بما يمهد لضمها للدولة العبرية، كلها عوامل جعلت الحراكات الجديدة تجمع بين العامِلين الداخلي المعيشي والإصلاحي من ناحية، والهم الوطني العربي والإقليمي من ناحية أُخرى، وانعكس هذا بجلاء في حالات رفع فيها المحتجون العلمين الجزائري والفلسطيني جنبا إلى جنب في “رمزية” تعني الكثير.
لا نستطيع أن نختم هذه المقالة دون الإشارة إلى تجربة الحراك الأردني، وإن كانت أقل زخما إلا أنها أسقطت حكومة، وأحدثت تحولا ملموسا في كيفية تعاطي السلطة مع مطالب المحتجين في مواجهة الفساد والإصلاح السياسي، والأهم من ذلك وقف اندفاعها، أي السلطة الأردنية، نحو صفقة القرن، وارتفاع منسوب الوعي الوطني الأردني بكل ألوانه، تجاه هذه الصفقة، وأبرز أخطارها تحويل الأُردن إلى وطن بديل، وإسقاط الولاية الهاشمية عن المقدسات في القدس المحتلة.
نحن أمام حراك شعبي حضاري سلمي منضبط أمامه فرصة كبيرة لكي يكون القدوة والنموذج لتغيير شامل للمنطقة بأسرها، عنوانه الأبرز الجزائر، فهذا الحراك، إذا استمر بالوتيرة نفسها سيصحح أخطاء جميع الحراكات و”الثورات” الأُخرى، ويحقق التعايش ويرسخ الوحدة الوطنية أيضا، فالجزائر التي يزيد تعدادها عن 43 مليونا وتعتبر الأكثر مساحة في المشرق والمغرب وإفريقيا، تملك الغاز والنفط والماء والشعب والتجربة الثورة المشرفة.. والأيام بيننا.
عبد الباري عطوان